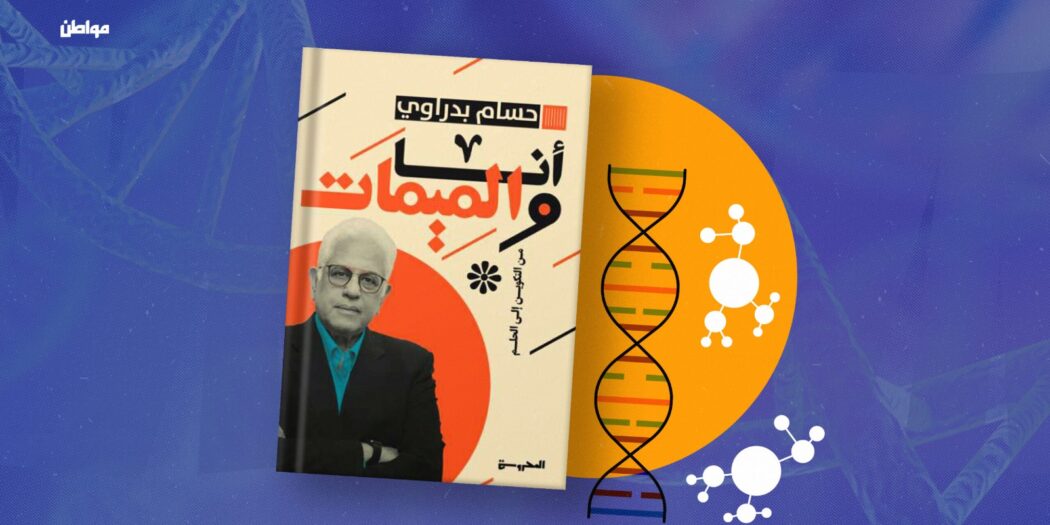أضواء على علم الميمات
بقلم سامح عسكر في 30/3/2024
منذ أيام أهداني الأستاذ والصديق العزيز “حسام بدراوي” كتابه الماتع والجديد ذا الفكرة غير المسبوقة في الفكر العربي، بعنوان، “أنا والميمات”، ويتلخص هذا الكتاب في استطلاع واستقراء الحالة الثقافية في الفكر العربي والإسلامي، بالاعتماد على أحدث العلوم النظرية في ذلك؛ وهو علم “الميمات” أو Memetics، ويعني دراسة التطور الثقافي بناء على المعرفة بالميمات التي تشكل وحدة جزئية للفكر والسلوك، مثلما تشكل المعلومات الوراثية وحدة جزئية للجينات.
ساق دكتور بدراوي كتابه في إطار علمي تجريبي أدبي مختلط؛ فهو سيرة ذاتية مفصلة بعض الشيء، تحكي تجاربه الواقعية في رصد واستقراء الحالة الفكرية والسياسية والدينية التي كانت عليها مصر في العقود الأخيرة، ومن تلك الزاوية يمكن الاسترشاد بالكتاب كقصة حياة مفكر ذكي ونابه يستخلص عصارة المجتمع لاستنتاج طبيعته وأسلوب حياته، والأهم هو المؤثرات الفكرية التي سارعت بانتقاله للتشدد الديني بهذه السرعة الملفتة؛ حيث إنه وبالنظر إلى واقع مصر قبل 50 عامًا مثلاً سنرى طبيعة مختلفة وميولاً واهتمامات مختلفة عن التي عليها الشعب الآن.
الفكرة التي ظهر عليها هذا العلم الجديد أنه مثلما يمكننا دراسة التطور البيولوجي الدارويني بدراسة علوم الأحياء والجينات الوراثية، كذلك يمكننا دراسة تطور الفكر بدراسة الميمات، وهي مجموعة أفكار وسلوكيات وقناعات قد يراها الإنسان صغيرة وهامشية، لكنها تشكل جزءً كبيرًا وهامًا في الثقافة وتطورها؛ فالميم هنا لا يعني بالضرورة أنه سلوك أو فكرة واقعية أو إيجابية، ولكنها قد تكون تعبيرًا عن خيالات وقناعات وهمية سلبية، لها ارتباط وثيق برغبات السلطات الدينية والسياسية والاجتماعية في النفوذ والسيطرة، ومن تلك الجزئية كتب الدكتور بدراوي كتابه لاستقراء أزمة من أزمات الفكر العربي والإسلامي من منظور علمي مختلف.
الميم هي معلومة أو تركيبة معرفية قابلة للتكاثر عبر عقول المُعيلين من بني البشر، وتؤثر على سلوكهم بحيث تجعلهم يساعدون الميم على الانتشار
يُعلق دكتور مراد وهبة في تقديمه للكتاب بقوله: “إن الميم مُشابه للحمض النووي؛ فكما أن هذا الحمض يحمل معلومات وراثية، كذلك الميم من حيث هو فكرة يحمل معلومة تتحول مع التطور إلى معرفة”. ويعلق دكتور أحمد عكاشة في تقديمه للكتاب بقوله: “إن مفهوم الميم الثقافي هو نتاج مفاهيم جديدة على غرار المفاهيم البيولوجية، وأن العلوم الاجتماعية من خلال هذه النماذج هي فهم حركة انتقال ودوران وتغير بعض الأفكار والثقافات، بالضبط كما يفهم الطبيعيون حركة الجينات؛ فمثلما توفر لنا الجينات القدرة على نقل الخصائص بيولوجيا عبر التكاثر؛ فالثقافة توفر نقل أنماط السلوك اجتماعيًا عبر التعليم أو التقليد، وكما تتضمن الجينات معلومات ذات دور تقريري في بناء الكائن وتكاثره، كذلك تحتوي الميمات – أو أنماط السلوك الثقافي – على معلومات ذات دور مهم في بناء المجتمعات البشرية”.
يضيف دكتور عكاشة: “إن الميم هي معلومة أو تركيبة معرفية قابلة للتكاثر عبر عقول المُعيلين من بني البشر، وتؤثر على سلوكهم بحيث تجعلهم يساعدون الميم على الانتشار، والميمة بالعموم هي أصغر وأبسط وحدة فكرية أو ثقافية تنتقل أو تتناسخ من عقل لآخر”.
ولكي ينتشر الميم وفقًا للدكتور بدراوي وضع عدة شروط يجب توافرها، هي بالأصل خصائص وشروط للأديان والأساطير الشعبية والتاريخية؛ فمن ضمن هذه الشروط:
 أولا: قابلية هذا الميم للتصديق.
أولا: قابلية هذا الميم للتصديق.
 ثانيا: أن تخص عددا كبيرا في المجتمع.
ثانيا: أن تخص عددا كبيرا في المجتمع.
 ثالثا: أن تكون مخيفة ومفزعة في جزء منها؛ فجميعنا نحب إفزاع بعض.
ثالثا: أن تكون مخيفة ومفزعة في جزء منها؛ فجميعنا نحب إفزاع بعض.
 رابعا: أن تكون سهلة الانتشار والانتقال.
رابعا: أن تكون سهلة الانتشار والانتقال.
 خامسا: أن يكون المناخ مستعدًا لها أو مضادًا؛ ففي الحالتين يكون الانتشار ممكنًا.
خامسا: أن يكون المناخ مستعدًا لها أو مضادًا؛ ففي الحالتين يكون الانتشار ممكنًا.
ولشرح ما يقوله هؤلاء من تعريف لعلم الميمات، يمكن ضرب بعض الأمثلة لتقريب المسألة، وأبدأ بما طرحه دكتور بدراوي في طرح نموذج للميم الثقافي المعرفي بالصفحة 75، وهي المعتقدات الدينية التي يعرفها الطفل؛ فهو لم يولَد بها لكن تعلمها من مجتمعه / أسرته؛ فمصادر المعرفة الأساسية لدى الإنسان ثلاثة؛ هي (الغريزة والثقافة والتجربة)، هنا الطفل ينشأ على وحدة معرفية صغيرة (الميم) لا علاقة لها بالثلاثة، ولكنه اكتسب هذه الميمة من الأسرة، وهي ميمة ثقافية متطورة عن الأجداد تم تلقينها للطفل دون سابق معرفة أو إنذار، أو حتى استعداد وإدراك لمعانيها، ولأن الطفل لا يفهمها فهي لا تنتقل من خلاله، ولكنها تكبر وتتطور في داخله بمؤثرات وظروف قد تكون مختلفة عن التي تعرض لها أجداده.
ومن هنا يكتسب الميم الجديد أبعادًا وصفات أخرى عن القديمة الموروثة، وهذا الذي يؤدي لتطور الأفكار والأديان، إن الذي يؤثر في تغيير هذه الأشياء وتطورها في التاريخ هي مؤثرات اجتماعية ومادية على تلك الميمة الموروثة – غير المُدرَكة – بالأساس، بالضبط مثلما يتطور الكائن الحي في الطبيعة؛ حيث يتغير شكله وطباعه وسلوكه بناء على تحديات ومؤثرات اجتماعية ومادية للأجداد، مثلما حدث للحيتان مثلاً في سلسلة تطورها من حيوان بري يمشي على أربع، إلى حيوان بحري يسبح بيدين صغيرتين في الأمام، وأرجل مطموسة تحت اللحم في الخلف.
ونموذج آخر حكاه دكتور بدراوي في الصفحة 46 وإن لم يسمها (ميم) ثقافي، لكن بالإشارة لوعيه بالميمات قرأت هذه الإشارة بين ثنايا السطور، وهو نموذج يحكي فيها محاولات جماعة الإخوان المسلمين عن طريق د. محمد مرسي وآخرين التقرب منه عندما كان رئيسًا للجنة التعليم في البرلمان المصري عام 2003؛ حيث طلبوا من الدكتور أن يتوسط عند جمال مبارك وإبلاغه بدعم الإخوان له كرئيس للجمهورية، هنا يتذكر تحذير اللواء “حسن أبو باشا”، والذي هو (حمو الدكتور بدراوي) من خطورة الإخوان إذا وصلوا إلى السلطة، وأن ما يريدون فعله مع جمال مبارك شبيه بما فعله الوهابيون والسلفيون مع العائلة المالكة في السعودية.
الميم الثقافي هنا هو “الانتهازية السياسية”، وقبول التحالف مع الأقوياء وطاعتهم لحين التملك والوصول لمرحلة التمكين، إن هذ الميم أهم ما يتصف به العنصر الإخواني والمنتمي للجماعات الإسلامية بالمطلق؛ حيث لا يترددون في قبول الدعم أو طلبه والإلحاح عليه من الأقوياء وذوي النفوذ، إذا ما ارتأوا في ذلك مصلحة آنية لهم تساعدهم على الحكم، أو الوصول بالحد الأدنى لدرجة من القوة اللازمة تمنع الحاكم من البطش بهم والتفكير مرات في الاعتماد عليهم، والتردد بكل الأحوال في تناولهم كجماعة لها نقاط ضعف وقوة تصبح مرغمًا لذوي النفوذ إذا فطنوا لتلك القوى واتخذوا قرارًا بالحوار معها.
ويمكن استقراء فكرة ”الإسلام هو الحل” كأشهر ميم ثقافي اعتمدت عليه الجماعات لتأصيل وتشريع الحكم الديني؛ فقد حصل على الشروط الخمسة لشهرة الميم؛ فضلاً عن فعاليته واعتماده على مجموعات كبيرة من الخلط والجهل والأمية بالمصطلحات والمفاهيم، نتيجة لتردي التعليم بالعقود الأخيرة.
وهو نفس الميم الذي أنتج ما يسمى “طاعة الحاكم” في الفكر الإسلامي؛ حيث يعلو طموح الفقهاء ورجال الدين في السيطرة والانفراد بالحكم، ولأنهم ليسوا من حملة السلاح، وبالغالب ليسوا من الأعيان؛ فهم بحاجة للتحالف أو التعاون مع هاتين الفئتين لضمان القوة اللازمة للبقاء من جانب، أو لضمان الحكم من جانب آخر؛ فالبشر لم يعرفوا قوة نفوذ وإخضاع وسيطرة أكثر من قوتي “المال والسلاح”، بمعنى أن الناس لا تحكمها سوى هذه القوى؛ فأي مجتمع تخضعه هذه القوى التي صنعت فكرة البوليس الأولى في التاريخ للسيطرة، أما قوة المال فلها مفعول السحر، وهي من النوع الناعم الذي يخاطب المصالح والضمير والأخلاق.
قوة البوليس والمال امتدادهم راسخ جدا في النفس البشرية ؛ فلا حاكم يحكم ويستقر إلا باقتصاد قوي وبوليس قوي، ولا جلسة عرفية تنجح في حل المشاكل القبلية إلا بوسطاء يجمعون بين الحُسنيين أو أحدهما، أما قوة العقل فهي تخاطب فئة محدودة من البشر، لكنها تصلح كجانب مكمل للقوى الأخرى، بمعنى أن الشرط الأساسي في الحاكم أو العمدة هو شيخ القرية أن يكون غنيًا مقتدرًا ولديه ما يعطيه؛ فلو كان فقيرًا أو صعلوكًا أو كادحًا لصار مكسورًا ولم يجرؤ على رفع عينه لحكم الناس وإقناعهم بنفسه، كذلك لابد لهؤلاء من شرطة تمكنهم من تخويف وإرهاب المنحرفين والمخالفين، وتساعدهم في بسط السيطرة وضمان استقرار حكمهم.
هنا تكون الانتهازية السياسية عند الجماعات ورجال الدين، تتفق مع الشروط الواجب توفرها في الميم لينتشر، واختصار هذه الشروط التي وضعها دكتور بدراوي، هو إيمان مجموعة كبيرة من الناس بها، والظرف الملائم لحضورها؛ فضلاً عن قابليتها للتصديق، ولا شك أن الخضوع للأقوياء مبرر منطقيًا وبدهيًا بدعوى البقاء.
ويمكن استقراء فكرة “الإسلام هو الحل” كأشهر ميم ثقافي اعتمدت عليه الجماعات لتأصيل وتشريع الحكم الديني؛ فقد حصل على الشروط الخمسة لشهرة الميم مثلما طرح ذلك دكتور بدراوي من جانب؛ فضلاً عن فعاليته واعتماده على مجموعات كبيرة من الخلط والجهل والأمية بالمصطلحات والمفاهيم، نتيجة لتردي التعليم بالعقود الأخيرة من جانب آخر؛ فقد انتقل هذا الميم كالعدوى وصار شعارًا مرفوعًا في المظاهرات والانتخابات دون إدراك لمعناه الخطير والاحتكاري الذي ينشر التكفير في المجتمع باستنساخ فاحش لتجربة الخوارج في صدر التاريخ الإسلامي.
إن دراسة التطور الثقافي في العقود الأخيرة تمكننا من فهم ماهية هذا الميم وكيفية انتشاره، وما تكوينه وعناصره؛ فقد اعتمد في تطوره على حب الناس للدين والعبادات وتعلقهم بشخصيات الرسول والصحابة وآل البيت؛ فاعتمد مروجو هذا الميم وناقلوه على هذا الحب بترديد أقوال وتفاسير هؤلاء الرموز والإكثار منها، لحد الإشباع والسيطرة، مقابل ترويج الميم بكراهية وازدراء غير المسلمين، أو الذين يُشَكُ في إسلامهم، ذلك لأن الميم في جوهره إما يثير شعورًا قويًا بالبهجة والسعادة مثل شعار الإسلام هو الحل، أو يثير شعورًا بالكراهية والاحتقار مثل تكفير غير المسلمين والمختلفين بالرأي في العموم.
فالميم ليس مجرد شعار؛ بل هو تطبيق عملي لإشارات وأحاديث ونظريات ، ومن خلال دراسة الميم يجري فهم تطور الإنسان والمجتمع من خلال تجاربه وخبراته؛ فكلما كانت تجاربه أكثر نضجًا كلما كانت ميماته أكثر نضجًا ودقة، والعكس صحيح، ولا شك أن الانتقادات التي وجهت للدولة الدينية في الغرب منعت احتكار المسيحية هناك بشكل كبير، وانخفض التكفير الضمني والمباشر، أو الادعاء بعدم خلاص وهرطقة وتجديف المختلفين بالرأي، بينما تجارب المسلمين تقول إنهم لم يتطوروا فكريًا بعد؛ حيث ومن خلال تجاربهم نرى أن ميامتهم ذات صفة احتكارية في الدين والسياسة والفكر.
هدف الدكتور بدراوي من كتابه أن دراسة الميم يمكننا من فهم طبيعة المجتمع والتنبؤ بمستقبله إلى حد كبير؛ فمثلما يتوقع علماء البيولوجي والتطور مستقبل الأنواع من خلال المعلومات الوراثية والسلوك، يتوقع المفكرون مستقبل الإنسان من خلال ميماته وسلوكه، وكأن هناك جدولاً للرياضيات وقيم إحصائية تشير إلى وجود بيانات لهذه الميمات، يمكن من خلالها البحث أو وضع خوارزميات معينة وشفرات تمكن الباحثين من التنبؤ بطبيعة ومستقبل هذا الكائن.
إن تديين العمل هو ميم ثقافي مشهور اعتمد على ميم آخر في سلسلة تطوره البنائي، وهو ”الاعتقاد بنهاية العالم”
ومن خلال قراءتي لكتاب دكتور بدراوي قفز إلى ذهني أحد هذه الميمات التي لم يتطرق إليها الدكتور، لكنها قريبة من المعنى الذي يشير إليه؛ فالجماعات الإسلامية عندما شرعت في الظهور السياسي والحضور الاجتماعي قبل خمسة عقود، كان ولابد أن يحدث هذا الظهور السياسي عقب تديين المجتمع شكليًا؛ حيث إن التدين الشكلي والطقسي سوف يكون حصان طروادة، أو هو السفينة التي من خلالها تعبر الجماعات لشاطئ الحُكم الديني.
فكان أحد أهم السلوكيات التي فعلتها الجماعات وأشارت إليها في الكتب الدراسية الداخلية، وهو (تديين العمل)، وقد اعتمدوا في ذلك على إقامة الصلوات الخمس جماعة في محل العمل؛ فلو لم يوجَد مكان لذلك يجري توفيره، بعدما كانت الصلاة في العمل فردية وتحدث بنظام المناوبات والاختيار الحر، لكن الطقس الذي تم ترسيخه منذ السبعينات أدى لبناء المساجد والزوايا في محل العمل، ثم ترك العمال ماكيناتهم وآلات الإنتاج للصلاة، وبنظام قهر الأغلبية من لم يكن يُصلي سيُصلّي رغمًا عنه منعًا للاتهام أو جلب الضرر لسمعته وكرامته على المستوى الاجتماعي، وقد رافق هذا الطقس سلوكيات أخرى تفرعت عنه، مثل تشغيل القرآن بأصوات عالية واستنكار سماع الأغاني.
وقد أدى هذا السلوك لتعزيز سلطة الجماعات أكثر، وانتقال المعيار الذي من خلاله يجري الحكم على الناس من الجوهر إلى الشكل، وانخفضت أهمية المعاملات والأخلاقيات لتصبح صلاة الفرد وقراءته وسماعه للقرآن هو المعيار الأوحد على صلاحه وتدينه وقربه من الله.
إن تديين العمل هو ميم ثقافي مشهور اعتمد على ميم آخر في سلسلة تطوره البنائي، وهو “الاعتقاد بنهاية العالم”؛ فكانت دعوى الجماعات تتلخص في أننا في نهاية الزمان، وعليكم بالتوبة قبل فوات الأوان؛ فأكثروا من إلقاء وسماع أحاديث النهاية وملاحم آخر الزمان التي احتلت جزءً كبيرًا من خطابهم الديني، حتى شعر الناس بالنهاية الحتمية، وساد شعور اللامبالاة ناحية الواقع الذي انحط أكثر وتخلف نتيجة لهذه العُزلة الشعورية؛ فاعتقاد الناس بالنهاية وقضاء الأجل المحتوم جعلهم يعيشون دون رغبة وطموح، وقتل في نفوسهم حب البقاء والإبداع بالتوازي مع إحياء ثقافة الموت والقبور؛ مما سهّل لدعاة الموت والدمار اختراقهم وجدانيًا؛ فانتشرت جماعات العنف والانتحار باسم الله دون رقيب وحسيب.
ومن أمثلة الميمات أيضًا ما يسمى “جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”؛ فالطابع الأساسي لها الجمع بين الفكرة والسلوك، أو بين النظرية والتطبيق، وهي تتسم بالاستدلال العقائدي والفقهي عند الجماعات، بغض النظر إن كان هذا الدليل صحيحًا وصادقًا في ذاته أم وهميًا، لكن هذا الميم يعد أحد أهم التطورات الفكرية التي اتسم بها الفكر الإسلامي في القرن العشرين؛ حيث لا تجد مثل هذا الميم حاضرًا في فكر الأولين كشرط أساسي لدولة الشريعة، لأن إحصاءه كشرط يعني فقدان تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما لم يحدث.
حيث تميزت المجتمعات القديمة بالحصار والمراقبة الاجتماعية على سلوكيات الأفراد قبل أن تتطور ثقافة الإنسان بالحرية الليبرالية منذ القرن 19م، لكنه ومن فقدان هذا الحصار وتلك المراقبة بالحريات ظهر هذا الميم كحاجة نفسية ومادية لضبط سلوكيات الأفراد ومنع الانحرافات الخلقية، وما يتعلق بذلك من ميول قهرية واستبدادية ضد الرأي الآخر بالعموم؛ فهو ميم هام جدًا يعطي ليس فقط معنى واحدًا، ولكن عدة معان مجتمعة تحقق مصلحة الناس وفقًا لرأيهم، إضافة لتطبيق صحيح الدين وما يتبعه من فرص النجاة في الدنيا والآخرة.
إن الفكرة الأساسية وراء طرح علم الميمات والقول به هو تبسيط العلوم المعقدة؛ فالتطور البيولوجي والحضاري للكائنات هو حالة عامة طالت كل شيء حتى الأفكار، ومثلما هناك عناصر مادية تحكم هذا التطور في الداروينية وفقًا لدوكينز، هناك عناصر معنوية تحكم تطور فكر الإنسان في التاريخ، ومن خلال هذا التطور تنشأ الحضارات؛ فيكون رصد هذه الميمات وتصورها بهذه الطريقة مقاربة بالمعلومات الوراثية في الجينوم، هو رغبة في اختزال هذا التعقيد العلمي في إجراء عمليات بسيطة يفهمها الشخص العادي.
لا توجد معايير متفق عليها تحكم عمل هذه الميمات وانتقالها؛ فالمعايير مختلفة باختلاف البشر، وقبول الناس لميماتهم الثقافية يظل أسيرًا للميول المسبقة والمصالح الشخصية
وهي طريقة عملية لكشف المشكلات وحلولها عن طريق أدوات للمقارنة؛ فمشكلة مثلاً داخل علوم الأحياء يمكن فهمها لو طرحت في سياق مختلف وليكن في علم الأفكار، حينها يمكن تصور هذه المشكلة المادية بشكل صحيح بتقريبها للذهن على شكل نظريات وبراهين عقلية ومشاريع فكرية، وليس أدل على ذلك من فكرة الاستنساخ الوراثي؛ حيث تحمل بصمات الجينوم معلومات وراثية موروثة من الآباء والأجداد، بالضبط مثلما تحمل الأفكار معلومات ورثها البشر من الآباء والأجداد عبر ما نعرفه بمركزية الأسرة في البناء الفكري والتعليمي للفرد، ومسؤوليتها في صناعة دين الأفراد وعقائدهم وأيديولوجياتهم المختلفة؛ فالنسخ الوراثي هنا ينطبق بشكل مذهل على النسخ المعلوماتي، وهي الفكرة التي يبدو أنها حفزت دوكينز على القول بالميمات.
ومع ذلك فالنظرية أو علم الميمات لا زال في بداياته، ويبدو أنه يعاني من بعض المشكلات ولم يُجب على بعض الأسئلة منها مثلا:
 أولاً: ما دقة المعلومات الموروثة والمنسوخة من الأفراد لبعضهم، وهل يمكن القول بأن ثمة زيفًا وأوهامًا كبيرة حصلت؟ هل توجد ضمانة بانتقال هذه المعلومات كما هي أم تعرضت للتشويه والتحريف؟
أولاً: ما دقة المعلومات الموروثة والمنسوخة من الأفراد لبعضهم، وهل يمكن القول بأن ثمة زيفًا وأوهامًا كبيرة حصلت؟ هل توجد ضمانة بانتقال هذه المعلومات كما هي أم تعرضت للتشويه والتحريف؟
 ثانيًا: إدراكات وقدرات الناس مختلفة ومتباينة للغاية؛ فمنهم من يملك مخيلة واسعة، ومنهم من توجد لديه تلك المخيلة بشكل أضيق، ومنهم من لا يملك أي مخيلة تمكنه من التصور والتجريد، ووحدة قياس ذلك على المشاع هي اختبارات الذكاء والرسم والتعبير وغيرها؛ فهل يمكن القول بأن تلك القدرات المختلفة لها دور سلبي وإيجابي في نقل ونسخ تلك المعلومات؟
ثانيًا: إدراكات وقدرات الناس مختلفة ومتباينة للغاية؛ فمنهم من يملك مخيلة واسعة، ومنهم من توجد لديه تلك المخيلة بشكل أضيق، ومنهم من لا يملك أي مخيلة تمكنه من التصور والتجريد، ووحدة قياس ذلك على المشاع هي اختبارات الذكاء والرسم والتعبير وغيرها؛ فهل يمكن القول بأن تلك القدرات المختلفة لها دور سلبي وإيجابي في نقل ونسخ تلك المعلومات؟
 ثالثًا: الناس أيضًا مختلفون نفسيًا، منهم من يواجه الصدمات بقوة وثبات انفعالي، ومنهم لا يملك هذه القوة والثبات، ومنهم من يملك منهما الشيء الضئيل؛ فانتقال ونسخ المعلومات ضمن حدود الميم الثقافي عرضة أيضًا للتشويه، وقد رأينا ذلك في مشكلة بناء المتطرفين فكريًا؛ حيث وبتعميم الخطباء وعدم شرحهم وتحريمهم للأسئلة أو امتناعهم عن إجابات بعض الأسئلة، تنشأ فراغات هائلة في عقل المتطرف يجيب عنها بنفسه وفقًا لتصوره لشخصية وميول شيخه في ذهنه، وليس الواقع الحقيقي لتلك الشخصية والميول.
ثالثًا: الناس أيضًا مختلفون نفسيًا، منهم من يواجه الصدمات بقوة وثبات انفعالي، ومنهم لا يملك هذه القوة والثبات، ومنهم من يملك منهما الشيء الضئيل؛ فانتقال ونسخ المعلومات ضمن حدود الميم الثقافي عرضة أيضًا للتشويه، وقد رأينا ذلك في مشكلة بناء المتطرفين فكريًا؛ حيث وبتعميم الخطباء وعدم شرحهم وتحريمهم للأسئلة أو امتناعهم عن إجابات بعض الأسئلة، تنشأ فراغات هائلة في عقل المتطرف يجيب عنها بنفسه وفقًا لتصوره لشخصية وميول شيخه في ذهنه، وليس الواقع الحقيقي لتلك الشخصية والميول.
ونرى هذه المشكلة بوضوح من واقع الحياة؛ حيث يدعي البعض أن تلاميذه وقراءه فهموه بشكل خطأ، وكثير من الخطباء والزعماء يتبرؤون من فكر وأفعال تلاميذهم إذا خالفت معقولاً أو معروفًا أو أي أخلاقيات وأديان وشرائع عرفها الناس؛ فالمشكلة أساسها من الخطيب والزعيم نفسه الذي حصر جهوده في حشد الجماهير لرأي واحد وامتناعه عن مناقشة وقبول الرأي الآخر؛ فتنشأ صورة عن ذلك الزعيم لدى التلاميذ أقرب للسلطة القهرية تكون مشغولة بشيء واحد فقط؛ هو تطبيق أفكارها بالقوة.
 رابعًا: لا توجد معايير متفق عليها تحكم عمل هذه الميمات وانتقالها؛ فالمعايير مختلفة باختلاف البشر، وقبول الناس لميماتهم الثقافية يظل أسيرًا للميول المسبقة والمصالح الشخصية، ويلجأ الناس في العادة إلى تصديق من يحبونه ولو كان كاذبًا، وإلى تكذيب من يكرهونه ولو كان صادقًا، لذا فتطور الميمات يظل عملاً معقدًا بحاجة لرصد نفسي وفكري مزدوج.
رابعًا: لا توجد معايير متفق عليها تحكم عمل هذه الميمات وانتقالها؛ فالمعايير مختلفة باختلاف البشر، وقبول الناس لميماتهم الثقافية يظل أسيرًا للميول المسبقة والمصالح الشخصية، ويلجأ الناس في العادة إلى تصديق من يحبونه ولو كان كاذبًا، وإلى تكذيب من يكرهونه ولو كان صادقًا، لذا فتطور الميمات يظل عملاً معقدًا بحاجة لرصد نفسي وفكري مزدوج.
 خامسًا: لم يتم تجريب الميمات الثقافية بشكل عملي، لذا فهي تظل أسيرة النظريات والفلسفة لتصبح قريبة للإبستمولوجي من العلم الطبيعي، والذي صنع هذه المشكلة أنه لم توضع بعد آليات متفق عليها لانتقال الميم من شخص لآخر، ولا زالت هذه الآليات محل دراسة واختلاف خاضعة للأحكام المسبقة في الغالب، لما تتضمنه النظرية/ العلم من فراغات ومساحات جدلية تطرح أسئلة أكثر مما تلقى من الإجابات.
خامسًا: لم يتم تجريب الميمات الثقافية بشكل عملي، لذا فهي تظل أسيرة النظريات والفلسفة لتصبح قريبة للإبستمولوجي من العلم الطبيعي، والذي صنع هذه المشكلة أنه لم توضع بعد آليات متفق عليها لانتقال الميم من شخص لآخر، ولا زالت هذه الآليات محل دراسة واختلاف خاضعة للأحكام المسبقة في الغالب، لما تتضمنه النظرية/ العلم من فراغات ومساحات جدلية تطرح أسئلة أكثر مما تلقى من الإجابات.
ومع ذلك فهذه المشكلات أو الألغاز التي تعترض علم الميمات لا تقول بنقضها أو نسفها أو اعتبارها وهمًا، ولكنها جزئيات ومجال تفسيرها بحاجة لجهد علمي لتنشيطها؛ فالداروينية منذ ظهورها منتصف القرن 19 ظلت أكثر من 100 عام تبحث عن كيفية انتقال الصفات الوراثية من كائن لآخر، إلى أن توصل الإنسان لعلوم الجينات الوراثية التي شرحت هذه الآلية التطورية بوضوح؛ فكان ظهور علم الجينوم مكملاً وخادمًا للداروينية بالأساس؛ فضلاً عن فراغات مست نظرية داروين تكلم عنها بنفسه في أصل الأنواع لا يتسع المقام لذكرها، ولكن الإشارة إليها واجبة للفت الأنظار إلى أهمية الاعتماد على الميمات لشرح وفهم التطور الثقافي.
أختم بأن الدكتور حسام بدراوي عندما تعرض لميمات القيم الإنسانية فقد اجتهد في تفكيكها وتجزئتها بالأسلوب التحليلي؛ فعندما يتعرض لقيم التضحية والطاعة مثلاً يجردها من معناها الشائع إلى تفصيلات أكثر دقة وواقعية، وهنا توجد ثمة حلول لبعض المشكلات الخمسة أعلاه، وأن الحل ينبع من تفكيك وتجزئة هذه الكُليات التي نصفها بالميم الثقافي؛ فالطاعة ليست واحدة؛ بل منها طاعة سلبية وأخرى إيجابية، والتضحية كذلك ليست مُعرفة بشكل واضح، والكبرياء كذلك، والذي يوجد منه تصور شعبي يعني الغطرسة وتصور أدبي يعني الاعتزاز بالنفس.
مما يطرح السؤال هو دقة هذه المعلومات المنسوخة في ذاتها تبعًا لتصور الناس للقيمة أو الميم الثقافي؛ فاختلاف الإنسان في تصور المعلومة قبل النسخ يعني أن الخطأ مؤكد في تصور تلك المعلومة بعد النسخ، وقد تتراكم المشكلة عملاً بقاعدة فساد الجذور وشدة فساد الفروع؛ فكلما فسد الجذر فسدت الفروع القريبة منه، واشتد هذا الفساد بالفروع الأبعد، أو العكس صحيح؛ فالجذر قد يكون طبيعيًا ولكن ثمة خطأ بسيطًا أو فوضى بسيطة لا تؤثر على عمل ونسيج الشجرة بالكامل؛ فتنمو بشكل طبيعي رغم أنها تعاني من مشكلات.
 د. حسام بدراوي الموقع الرسمي
د. حسام بدراوي الموقع الرسمي