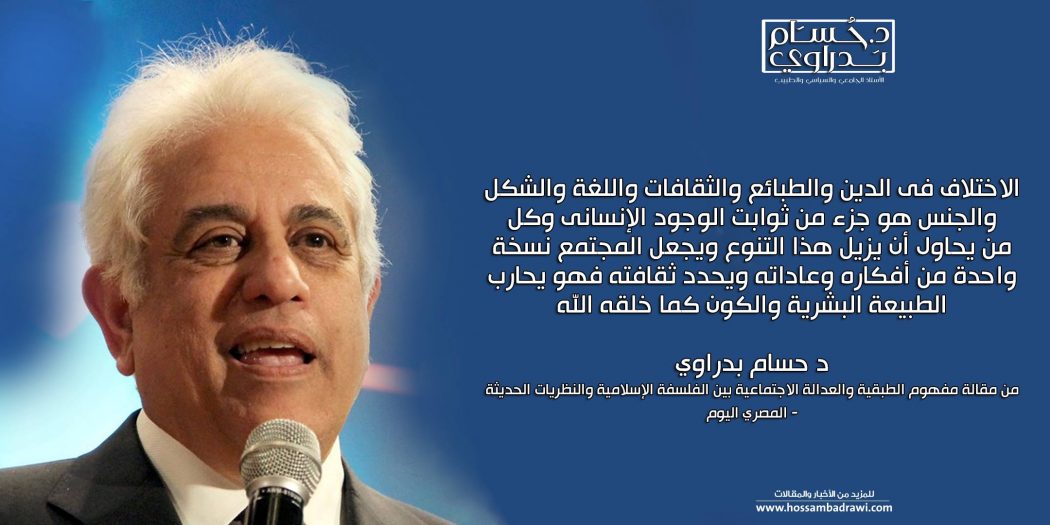الطبقية مفهوم ظهر بقوة فى الأدبيات الماركسية، التى ذهبت إلى إنكار وجودها كتفاعل إنسانى طبيعى على مستوى التنظير، ودعت إلى إلغاء الفوارق بين الناس على مستوى التطبيق، واعتبرت أن هذا التفاوت يستدعى صراعًا على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، وقررت أن الصراع الطبقى هو الحاكم والمتحكم فى علاقات الإنسان على المستويات كافة؛ ومن ثم رأت أن هذا الصراع حتمى فى المجتمعات، ويجب أن يفضى فى النهاية إلى زوال الطبقات من تلك المجتمعات، وسيادة طبقة واحدة هى طبقة البروليتاريا.
وفى هذا التوجه قررت الشيوعية وتوابعها أن الملكية يجب أن تكون عامة لهذه الطبقة وأن الجميع متساوون من حيث الوضع الاجتماعى فالكل موظف لدى الدولة وأن المبادرات الفردية يجب أن يعود نتاجها على المجتمع وليس على الفرد. ومن هنا تطرف التطبيق وأصاب المبادرة الفردية فى مقتل وخلق طبقة حاكمة طابقة على أنفاس المجتمع بحجة حماية الطبقة العاملة التى يتساوى فيها الجميع فى عدم الملكية الخاصة والفقر.
أما الرأسمالية فقد تعاملت مع هذا المفهوم من منظور آخر، فهى من جانب أقرت هذا التفاوت بين الطبقات على مستوى التنظير، وعملت على ترسيخه على مستوى التطبيق، فأطلقت للأفراد حرياتهم دون قيد أو شرط، وجعلتهم المالكين الوحيدين لما يكتسبون، ولا حق فيه لغيرهم سوى من خلال نظم ضرائبية تكفل سداد الأغنياء لنسبة من أرباحهم لمجموع المجتمع واتخذت الاحتياطات القاسية ضد من يتهربون من سداد هذه الضرائب. وفى نفس الوقت منعت الدولة من القيام بأى تدخل فى سلوك الأفراد، واعتبرت أن سيطرة القوى والغنى هو القانون الذى يحكم المجتمعات والعلاقات بين الناس. واعتبرت الرأسمالية فى شكلها الأمريكى المتطرف أن وجودها يعتمد على القوة الاقتصادية للشركات والأفراد الذين يحمون هذه الفلسفة بتحكمهم أيضا فى الحكم حتى وإن أخذ شكل الديمقراطية التى أصبحت قوة المال والمصالح الاقتصادية تتحكم فى مقدراتها بدرجات متفاوتة.
ولقد شغلنى موضوع تفاوت الطبقات والعدالة منذ كنت طالبا فى الجامعة فى (١٩٦٩: ١٩٧٤) أحاور الشيوعيين واليساريين من زملائى حيث كان وجودهم مؤثرا فى الحياة السياسية بعد عقد من الزمان شهد توجها سياسيا مصريا يميل إلى اليسار ويعتمد على الاتحاد السوفيتى فى مواجهة الغرب الرأسمالى المؤيد لإسرائيل والممثل تاريخيا للمستعمر. كنت فى ذلك الوقت ومازلت نتاج خمسة مؤثرات على تكوينى الثقافى والاجتماعى والسياسى. أولها: التأثر الشديد بأهمية المستوى العالى للتعليم والمهارة والمبادرة الفردية والقطاع الخاص وتأثيرها الإيجابى على التنمية بحكم تكوينى العائلى. وثانيها أهمية البعد الاجتماعى للثروة بحكم فلسفة والدى العظيم رحمة الله عليه الذى أرسى فى وجدانى قيمة العدل بين الناس. وثالثها تأثير التعليم العام والإعلام على بنائى الثقافى تلميذا فى مدرسة الأورمان العامة ثم طالبا فى كلية الطب مع زملاء من مختلف طبقات المجتمع بلا تفرقة. ورابعها ارتباطى ناشئا فى فريق كرة القدم بالنادى الأهلى وجمهوره من كافة الطبقات. وخامسها بحثى وشغفى وقراءاتى للأستاذ العقاد والدكتور طه حسين وعبدالرحمن الشرقاوى من بداية حياتى فى المدرسة الثانوية
ونظرا لشغفى بالمعرفة فى السبعينيات وبداية ظهور تيار الإسلام السياسى مرة أخرى جانبا إلى جنب مع التيار السياسى اليسارى، فى ذلك الوقت، بالجامعة، ورغبتى وفضولى فى نقاشهم فقد بحثت أيضا فى موقف القرآن من ظاهرة التفاوت الطبقى لأعلم موقفه أولا، لأنى كنت حائرا. وثانيا، لأنى أردت استخدام مرجعيتهم فى النقاش. ولقد كان ذلك مثريا لعقلى ووجدانى ومثيرا فى نفس الوقت حيث بدأت قناعاتى تتكون وتكتسب بالعلم والمعايشة واكتساب الخبرة.
وحسبما تعودت عليه فإننى احتفظت بأوراقى وملاحظاتى عن هذه الحقبة من حياتى، وعندما طلب منى ابنى مساعدته فى بحث كان لديه بحث فى الجامعة بعدها بعشرين سنة حول نفس الموضوع من منطلق الفلسفة الإسلامية،(ابنى كان فى جامعة ديوك بالولايات الأمريكية) وطلب مساعدتى فرجعت لأوراقى وأنا طالب وازددت بحثا بنضوج أعمق واسترجعت العديد من الآيات القرآنية التى كان قد جمعها غيرى، والتى ألمحت إلى ظاهرة التفاوت الطبقى بين الناس؛ من ذلك قوله تعالى: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} (النساء:٣٢)، وقوله سبحانه: {والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق} (النحل:٧١)، وقوله تعالى: {انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض} (الإسراء:٢١)، وقوله سبحانه: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات} (الزخرف:٣٢). فهذه الآيات ونحوها تقرر حقيقة واقعة وهى أن الله قد فضل الناس بعضهم على بعض بشتى أنواع التفضيل؛ فضلهم بالرزق فمنهم الفقير ومنهم الغنى. وفضلهم بالجسم فمنهم القوى ومنهم الضعيف. وفضلهم بالعقل فمنهم العالم ومنهم الجاهل. وفضلهم بالشكل فمنهم الجميل ومنهم القبيح وفضلهم بالأخلاق فمنهم حسن الخلق ومنهم سيئ الخلق. وأشير إلى الآية التى أحبها ويتغير فهمى لها كلما ازداد علمى ومعرفتى ونضوجى الفكرى «إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت».
إذن، القرآن الكريم يقرر ظاهرة التفاوت بين الناس. وهو إذ يفعل ذلك إنما يفعلها لحكمة يريدها، ولو كان الناس كلهم فى مستوى واحد من الرزق لما احتاج أحدٌ لأحد، ولم يعد ثمة مسوغ للدعوة لفعل الخيرات، وعمل الصالحات.
ومن الناحيه الفلسفيه فلا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بهذا التفاوت؛ وذلك أن التفاوت ضرورى لتنوع الأدوار المطلوبة لعمارة هذه الأرض. ولو كان جميع الناس نسخًا مكررة ما أمكن أن تقوم الحياة على النحو المطلوب، ولبقيت أعمال كثيرة لا نجد لها من يقوم بها. والذى خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها.
ومع أن القرآن قد أقرَّ هذه الظاهرة الإنسانية، بيد أنه لم يكتف بذلك، بل سعى للحد قدر المستطاع من هذا التفاوت. فعلى مستوى التفاوت الاقتصادى بين الناس، طلب من الغنى الإنفاق على الفقير، ومدِّ يد العون له، كما قال تعالى: {وأنفقوا مما رزقناكم} (المنافقون:١٠). وهو على هذا المستوى لم يسع إلى العمل على محاربة ما فطر الله عليه الناس من تفاوت واختلاف، ولم يسع كذلك كما فعلت بعض المذاهب وكما يفعل عدد من السياسيين الآن فى مصر، إلى إثارة طبقة ضد أخرى، بل وقف موقفًا متوازنًا لإقامة المجتمع على أساس التوازن بين طبقاته. فليس المقصود إفقار الأغنياء، بل مساعدة الفقراء وتأمين احتياجاتهم وخروجهم من دائرة الفقر.
وبالمقابل، طلب من الفقير ألا يتمنى ما فضل الله به غيره من الناس، كما قال تعالى: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}. ومدح المتعففين من الفقراء، فقال: {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا} (البقرة:٢٣٧). وأيضًا طلب من الناس السعى فى طلب الرزق والكد من أجل تحصيله، قال تعالى: {هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه} (الملك:١٥)،.
وعلى مستوى التفاوت الفكرى، طلب القرآن من العالِم أن يُظهر علمه، ولا يكتمه عن الناس، وتوعد من يفعل ذلك أشد الوعيد، قال سبحانه: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون} (البقرة:١٥٩). فالعالِم مطالب أن يعلم غيره، ولا يكتم علمه فى صدره.
وبالمقابل، حضَّ القرآن غير المتعلم على طلب العلم، وميَّز بين العالم وغير العالم، ما يفيد مدح الأول وذم الثانى، كما قال تعالى: {قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون} (الأنعام:٥٠)، وقال تعالى: {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون} (الزمر:٩)، وطلب من غير المتعلم أن يسأل العالم، قال سبحانه: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل:٤٣) فغير العالم مطالب بأن يتعلم ولا ينبغى أن يبقى جاهلاً.
إن فلسفه القرآن كما فهمتها قررت أن الحياة الكونية قائمة على أساس قاعدة {ومن كل شيء خلقنا زوجين} (الذاريات:٤٩)، وعلى أساس هذه القاعدة الكلية فى بناء هذا الكون، خلق الله الناس ذكرًا وأنثى، وجعل سبحانه ابتداء الرجل رجلاً والمرأة امرأة؛ وأودع كلاً منهما خصائصه المميزة؛ ليؤدى كل منهما وظائف معينة. لا لحسابه الخاص، ولا لحساب جنس منهما بذاته. ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التى تقوم، وتنتظم، وتستوفى خصائصها، وتحقق غايتها عن طريق هذا التنوع بين الجنسين؛ والتنوع فى الخصائص، والتنوع فى الوظائف. وعن طريق هذا التنوع، ينشأ تنوع التكاليف، وتنوع الأنصبة، وتنوع المراكز، لحساب تلك المؤسسة العظمى، المسماة بالحياة.
إذن فلسفة الإسلام أقامت الحياة الاجتماعية على أساس التفاوت بين الناس. ولم يقع يوماً حتى فى المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة أن تساوى جميع الأفراد فى هذا الرزق أبداً. ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتمًا {ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا} (الزخرف:٣٢). و(التسخير) -وفق المنظور القرآني- لا يعنى استعلاء طبقة على طبقة، أو استعلاء فرد على فرد حيث إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض ليس بمفهوم العبودية ولكن بمفهوم طبيعة الاحتياجات والقدرات والمهارات لأن الحياة تستمر وتدار بالجميع، حيث يسخر بعضهم لبعض فى كل وضع، وفى كل ظرف. المقدَّر عليه فى الرزق مسخر للمبسوط له فى الرزق. والعكس كذلك صحيح. فهذا مسخر ليستثمر المال، وينشئ الوظائف فيعمل الآخرون ويرتزقوا، والتفاوت فى الرزق هو الذى يسخر هذا لذاك، ويسخر ذاك لهذا فى دورة الحياة. العامل مسخر للمهندس، ومسخر لصاحب العمل. والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل. وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على حدٍّ سواء. وكلهم مسخرون للخلافة فى الأرض بهذا التفاوت فى المواهب والاستعدادات، والتفاوت فى الأعمال والأرزاق.
والقرآن إذ يقرر هذا التفاوت بين البشر لا يدعو إلى ترسيخ هذا التفاوت وتنظيمه، بل غاية ما فى الأمر أنه يقرر الحقائق الخالدة فى فطرة هذا الوجود. وحتى الاختلاف فى الدين والطبائع والثقافات واللغه هو جزء من ثوابت الوجود الإنسانى وكل من يحاول أن يزيل هذا التنوع ويجعل المجتمع نسخة واحدة من أفكاره وعاداته ويحدد ثقافته فهو يحارب الطبيعة البشرية ويمنع التنمية النفسية والعقلية التى تتمتع بها المجتمعات ذات التنوع مثل مصر.
أود أن أقرر، أن فلسفة الدين الإسلامى حسب فهمى قد أقرت ظاهرة التفاوت بين الناس، واعتبرت ذلك من المقتضيات الملازمة لاستمرار هذه الحياة، ودعت فى الوقت نفسه إلى تقليل هذه التفاوت قدر المستطاع، لكنها لم تسع إلى إلغائه؛ لأن فى ذلك إلغاء لسنة من سنن الحياة.
ومن هنا أعود لمفهوم العدالة الاجتماعية الذى يتكلم عنه السياسيون والثوريون هذه الأيام بغموض غير محدد لتوزيع الدخل واتهام ضمنى لمن يحقق الربح بعدم الأمانة واتجاه للملكية العامة والعودة إلى القطاع العام حتى ولو كانت تحقق الخسائر رغبة فى المساواة فى الفقر تحقيقا للعدالة بين الناس!!
لذلك فلابد من أن يكون لدينا فلسفة ورؤية للعدالة قبل الخوض فى إجراءات فرعية قد تؤدى إلى إفقار المجتمع كله فى الطريق إلى تحقيق هذه العدالة، وسياسات الإنفاق العام والضرائب هى إحدى وسائل المجتمع لتحقيق أهداف تحقيق العدالة فى المجتمع بتوازن بين بقاء حافز النجاح وتحقيق الربح واحتياجات الإنفاق العام الذى سأشرحه فى السطور القادمة.
إننى أرى أن هناك فلسفتين مختلفتين تتعاملان مع العدالة الاجتماعية: الفلسفة الأولى تتعامل مع العدالة الاجتماعية كنتيجة يتعين الوصول إليها بغض النظر عن عدالة الوسائل، مثلما فعلت الشيوعية وكما يدعو بعض السياسيين فى مصر الآن، والفلسفة الثانية تتعامل مع العدالة الاجتماعية بوصفها عدالة الفرصة ومكافأة المجهود وفى نفس الوقت إتاحة خدمات وحقوق معينة للجميع كالتعليم والرعاية الصحية والمواصلات العامة والصرف الصحى والمياه النظيفة مثلا بغض النظر عن تفاوت الدخل بالإضافة إلى الإنفاق على مؤسسات العدالة (القضاء) ومؤسسة الدفاع عن الوطن (والجيش) ومؤسسات تطبيق القانون (الشرطة) وهى الفلسفة الأقرب إلى عقلى ووجدانى فى تحقيق حد معروف من الحقوق وفى نفس الوقت مكافأة العمل والاعتراف بتعدد واختلاف القدرات والرزق.
ولقد أثبتت الدراسات والتجارب أن السياسات الاقتصادية التى تعضد الاستثمار فى القوى البشرية وتكافؤ الفرص تسهم فى دعم النمو الاقتصادى والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية أكثر من مجرد الأخذ من الأقدر للتوزيع على الأقل قدرة.. وباستثناء السياسات الاجتماعية الانتقالية أو المباشرة التى يجب أن تستهدف الفئات المهمشة مثل المعاقين وكبار السن والمرضى والأيتام وكذلك المناطق الجغرافية النائية التى لا تملك موارد تنموية يجب أن تكون سياسات الإنفاق العام على التمكين وتكافؤ الفرص هى السياسات الرئيسية لتضمين كل فئات المجتمع فى النمو الاقتصادى والتشغيل ونمو الدخل.
إن السياسات الاقتصادية باختلافاتها منذ آدم سميث «أب الاقتصاد الحديث» تؤكد أن «العمل والإنتاج والكفاءة» هو أصل تحقيق إعادة توزيع الدخل. وتشير التجارب الدولية إلى أن سياسات الإنفاق العام هى الأداة الأولى لإعادة توزيع الدخل نحو تحقيق نمو اقتصادى قائم على التشغيل أكثر عدالة، لأنها الأدوات التى تحقق تكافؤ وشفافية الفرصة بين القوى البشرية. ويتحقق تكافؤ الفرصة من خلال الإنفاق على نظام تعليم أساسى لا يفرق بين الغنى والفقير أو المهمش، ونظام أساسى للخدمات الصحية لا يميز بين الطبقات، وسبل انتقال عامة كريمة إلى العمل من خلال الاستثمار فى البنية التحتية، ومناخ أعمال شفاف يمنع الاحتكار ويحمى أصحاب الأعمال الصغيرة ويضمنهم فى العملية الإنتاجية وفى خلق فرص عمل كريمة وتوليد دخول لأسرهم. فإذا قامت الحكومة بدورها فى وضع لبنة الفرص المتكافئة والمتاحة بشفافية للجميع يسهم الجميع من خلال عملهم فى تحقيق النمو الاقتصادى- زيادة حجم الكعكة- ونمو الدخل لجميع العاملين من خلال جنى ثمار النمو الاقتصادى الذى يساهم فيه كل العاملين- أى نصيب أكبر من الكعكة لكل مجتهد. ومن خلال ثمار هذا النمو تتاح الفرصة لإعادة توزيع نسبة منه على المهمشين كما تم تعريفهم. وهنا علينا أن نفهم تحقيق العدالة الاجتماعية بهذا المفهوم يقع على الدولة كمنظم وضامن للحقوق وعلى المواطن القادر فى استعمال أمواله لخلق فرص عمل جديدة والعامل بجهده وإتقانه لعمله لتحقيق مزيد من الدخل والرفاهية له ولأسرته ومجتمعه عملاً بالآية القرآنية «إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا». وتتجلى الفلسفة الإيجابية للعمل مرة أخرى فى الآية القرآنية «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» التى تضع عبء تغيير الحال على الفرد ومجهوده وليس على الرب فما بالك الدولة.
وتحتاج مثل هذه السياسات الموجهة لتحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية إلى موارد ضخمة وإدارة كفء ورؤية واضحة للدولة وواضعى السياسة. وهنا يأتى دور الزاوية الثانية من سياسات المالية العامة وهى السياسات الضريبية. ومرة أخرى يواجه الاقتصاديون إشكالية تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال منظومة منصفة أيضاً لدافعيها ومجهود عملهم. ويواجه إرساء منظومة ضريبية كفء ومنصفة عدة تحديات فى الدول النامية التى تكون الأعمال الصغيرة والأعمال غير الرسمية التى لا تسهم فى دفع الضرائب النصيب الأكبر من الاقتصاد، إضافة إلى تهرب الكثير من أصحاب المهن الحرة فى ظل منظومة ضريبية ضعيفة غير ممكنة وبالتالى غير قادرة على الحصر والتحصيل الرسمى من خلال الإيصالات. فمثلا سنجد فى مصر أن أقل من عشرة بالمائة من المؤسسات تسدد أكثر من ثمانين بالمائة من الضرائب ليس فقط لأن نظام التحصيل غير كفء ولكن لوجود هؤلاء الأفراد والمؤسسات الصغيرة خارج نطاق رادار التنظيم والمتابعة.
والأهم لتحقيق العدالة هو كفاءة منظومة إدارة تحصيل الضرائب، وهو الأمر الذى كان قد بدأ يأخذ مجراه منذ التعديل التشريعى ٢٠٠٥ والذى بدأت ألحظ الرجوع فيه فى السنوات الأخيرة وعودة ضغوط محصلى الضرائب التى كانت قد بدأت تختفى فى بداية عهد للثقة بين مصلحة الضرائب والمواطنين مما سيسرب الكثير مما يسدد إلى خارج الإطار الشرعى للدولة.
إن العدالة الاجتماعية تتأتى بتوفير حقوق المواطن من الخدمات العامة كما قلت فى التعليم والرعاية الصحية والنقل العام والبنية التحتية وتطبيق القانون على الجميع وتحقيق تكافؤ فى الفرص لكل مواطن بناء على قدراته ومهاراته وليس على مجرد وجوده. وكل ما أذكره هنا يحتاج إلى تمويل من المجتمع وإدارة كفء من الحكومة ورقابة على الإنفاق العام ليحقق أهدافه المعلنة. فإذا جاءت حكومة وثبتت عمالة زائدة أو صرفت أرباحا لم تتحقق أو تعسفت لتغلق مصنعا أو وحدة إنتاج فإنها وإن أرضت فئة من المجتمع إلا أنها بالقطع قد انتهكت فلسفة العدالة الاجتماعية للكل لصالح فئة وإن كان لها حق من وجهة نظرها.
إننى ومن خلال هذه المقالة، وأنا غير متخصص وأتكلم بلغة المواطن الذى يدرس ويدقق فيما يتم تداوله سياسيا، على الساحة أردت أن أشارك الرأى والفهم لعبارات يتم تداولها وشرحها بغير معناها مما يؤدى إلى عكس المقصود منها. فكم من الجرائم يتم ارتكابها تحت اسم العدالة الاجتماعية فى مصر.
 د. حسام بدراوي الموقع الرسمي
د. حسام بدراوي الموقع الرسمي